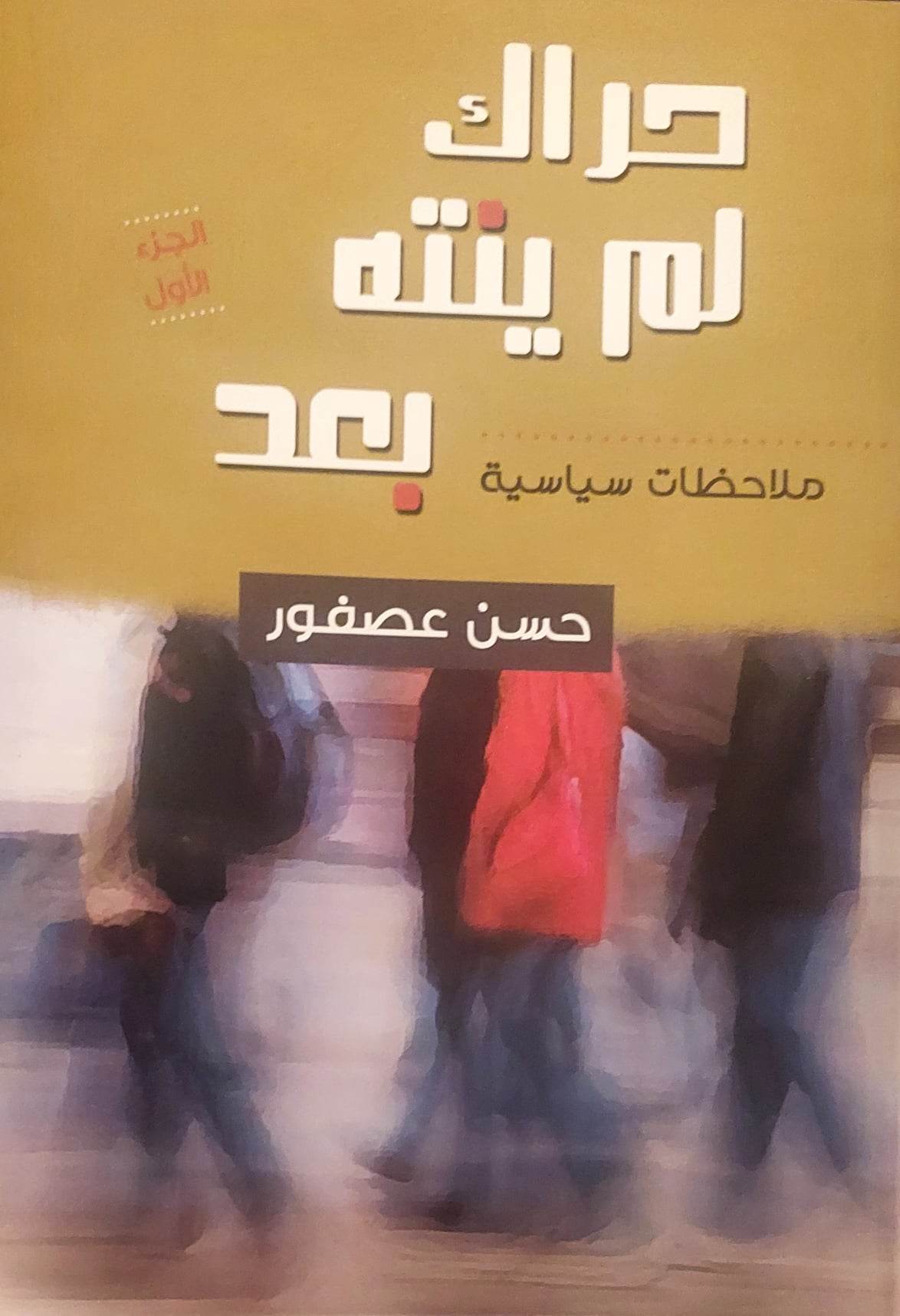كتب حسن عصفور/ منذ زمن ومسألة العلاقات الأمريكية مع العربية السعودية دخلت مرحلة يمكن اعتبارها، الأكثر توترا وسلبية منذ بدايتها، ولم تعد بتلك السلاسة السياسية، وخاصة مع انتخاب الرئيس بايدن، واغتيال الصحفي جمال الخاشقجي، بكل ملابساتها وحقيقة الطرف المنفذ، وتركيز نواب من الكونجرس اتهام الرياض وتحديدا الأمير الشاب (الحاكم الفعلي) للمملكة، وباتت غالبية السلطة بيديه، وجاءت القمة العربية لتعلنه موضوعيا ملكا غير متوج بالمعني التقليدي، لتكون رسالة الى ما سيكون قادما.
ورغم تلك العناوين “البراقة”، لكن الجوهري الذي أربك تلك العلاقات لا يرتبط كثيرا بقضية الخاشقجي وقضية اليمن التي شكل موقف الإدارة الأمريكية فيها استغرابا، خاصة وأن القضية تتعلق بأحد أشكال المواجهة مع النفوذ الإيراني وانقلاب الحوثيين على الشرعية واغتيال الرئيس علي عبد الله صالح، لكنها أداة استخدامية للتضيق.
جوهريا يمكن الإشارة الى سلوك الأمير الشاب الطامح لدور إقليمي يتجاوز كل ما كان حضورا للعربية السعودية، لتصبح صاحبة قرار مركزي، وتلعب دورا “قياديا” وليس مرتبطا، بحكم ما تمتلك من قدرات، ما انعكس على تغيير في مسار العلاقات السعودية مع دول العالم، وبالتحديد مع الصين وروسيا، مع نمو استثماري كبير وتحالف ما يعرف بـ “أوبك +”، والذي رأته واشنطن خطرا استراتيجيا على مكانتها أولا، وتعزيز “النزعة الاستقلالية” للسعودية ثانيا، ودعم مباشر الى روسيا عبر ارتفاع أسعار النفط مع خفض الإنتاج.
وتحتل قضية “التطبيع” بين دولة الكيان والعربية السعودية مكانة خاصة، ضمن القضايا المتشابكة بين واشنطن والرياض، باعتبارها ستكون أحد عناصر “التقييد الأمريكي” للنزعة “الاستقلالية” التي يحاول بن سلمان تنفيذها، وخاصة أن إسرائيل تقدم ذاتها “قوة دفع استراتيجية” على المستوى العسكري – التكنولوجي، ما يمكنه أن يعوض بعضا من الحظر الأمريكي لمتطلبات السعودية وأميرها.
وآخر، طبعات ملامح “الصفقة الأمريكية” التي يتم الترويج لها ما نشره الصحفي الأمريكي توماس فريدمان في “نيويورك تايمز” يوم 27 يوليو 2023، بعدما نشرت الصحيفة البريطانية “ايكونوميست” يوم 5 يوليو 2023، تقريرا عن طلبات بن سلمان من أمريكا مقابل “التطبيع” مع إسرائيل، حددتها بأسلحة وتكنولوجيا وبرنامج نووي، وصيغة مقبولة لحل القضية الفلسطينية.
فريدمان، أشار الى أنه تحدث مع الرئيس بايدن حول “التطبيع” السعودي – الإسرائيلي، وحدد مطالب الرياض بـ “معاهدة من شانها إلزام أمريكا بالدفاع عن السعودية إذا ما تعرضت لهجوم، على يد إيران على ما يبدو، وبرنامج نووي مدني يشرف عليه الأمريكيين، والسماح لها بشراء اسلحة أمريكية أكثر تطورا، مثل منظومة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ البالستية”، مقابل مطالب أمريكية تتلخص “التزام بإنهاء القتال في اليمن، تقديم حزمة مساعدات كبيرة وغير مسبوقة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة، ووضع قيود كبيرة على علاقاتها الدافئة مع الصين”.
وبالتأكيد أيضا قضية الطاقة والنفط وخاصة سياسة “أوبك+” التي كانت يوما سلاحا أمريكيا ضد المعسكر الاشتراكي وخاصة الاتحاد السوفيتي، باتت سلاحا دافعا لروسيا ورئيسها بوتين.
المطالب المتبادلة، بعضها شكلي، وقد يتم التخلي عنه، مقابل ما هو رئيسي، فالتطبيع، تدرك العربية السعودية وحاكمها بن سلمان، انه “حلم أمريكي” يفوق كثيرا ما لدولة الكيان، ولذا يتعامل معه باعتباره “الجائزة الكبرى” التي ينتظرها، وتقديم حل للقضية الفلسطينية ما يعزز “الطموح الإقليمي الكبير”، بل واستبدال أدوار بأدوار، وأنها البلد العربي الذي تمكن من فرض حل سياسي خاص بفلسطين.
وسريعا أرسل بايدن مستشاره للأمن القومي سوليفان، يوما بعد نشر ملامح صفقته، ومن تركيبة وفده يمكن تأكيد ما ورد فيما نشره فريدمان، وخاصة وجود مستشار بايدن لشؤون الطاقة، (نووي والنفط)، ورغم عدم تركيز الإعلام الرسمي السعودي على تلك الزيارة، بل لم ينشر صورة مشتركة في يومها الأول، كرسالة أن الطريق لا زال غير سالك، لكنها بدأت تشق سبلها.
وبالتزامن بدأت العربية السعودية التحرك أوروبيا لصياغة جديدة لـ “مبادرة السلام العربية”، التي قدمتها عام 2002 في قمة بيروت، محاولات تتوافق والذهاب نحو علاقات مع دولة الكيان، ربما بـ “شروط” مختلفة عن الأصل، وخاصة بعدما تم اختراقها من قبل دول عربية بتوقيع ما يعرف بـ “اتفاقات إبراهيم”، ولكنها محاولات تشير أن القضية الفلسطينية تمثل جزءا هاما للحراك السياسي السعودي.
والسؤال، هل حقا يمكن لأمريكا، أي كان نظامها فرض حل سياسي “ممكن” أو “مقبول” يتقارب مع قرار الأمم المتحدة عام 2012 لتصبح دولة عضو مراقب رقم 194، حول دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967، مع حكومة سموتريتش وبن غفير، بالتأكيد ساذج وغبي من يعتقد ذلك.
وافتراضا أن أمريكا، نجحت في اسقاط حكومة الفاشية المستحدثة، واستبدلتها بتحالف أقرب لمصالحها الاستراتيجية من الحكومة القائمة في الكيان، هل يمكن فرض حل سياسي يتوافق مع جوهر مبادرة السلام العربية، وإن تعدلت لتخدم الحراك السعودي الجديد، ولا يبتعد كثيرا عن قرار الأمم المتحدة حول فلسطين الدولة والحدود والعاصمة.
هل يمكن للعربية السعودية، أي كانت الإغراءات الأمريكية لتقديم صفقة لها، تمنحها حضورا إقليميا يتوافق وطموح الأمير الشاب، أن تسير دون مصر والأردن ودولة فلسطين…بالتأكيد الجواب السريع وبدون أي منقبات كلامية سيكون لا كبيرة جدا.
وكي لا تستمر لعبة “إغراءات” تتوافق وبعض “الطموحات السياسية”، بعضها مشروع وحق وبعضها قد يكون عائقا حقيقيا أمام الحق لصالح اللاحق، وخاصة محاولة استبدال أدوار دول بغيرها، سيكون أفضل للرياض وبن سلمان، ربط حل القضية الفلسطينية والتطبيع في “إطار عربي مقلص”، تشمل طرفها الرئيسي دولة فلسطين مع الجامعة العربية ومصر والأردن الى جانب السعودية.
الذهاب في مسار سعودي منفصل لمعادلة “تطبيع مقابل حل للقضية الفلسطينية” سيكون فخا سياسيا كبيرا، لن تخرج منه الى زمن طويل، وستفقد كثيرا من “بريق” انطلاقتها الراهنة، وستتحمل عبئ إنهاء القضية الفلسطينية من بعض جوانبها مع صيغة احتلالية مستحدثة.
الطموح الذاتي لتعزيز مكانة دولة أي دولة، حق ولكنه لا يجب أن يكون بأي ثمن، وخاصة في قضية ستبقى مركز الصراع أي كانت حالة ممثلها الرسمي، أو التطبيع العربي الرسمي مع عدوها.
ملاحظة: غريب أمر الجماعة الإخوانجية، يذهبون الى بلاد فارس راكعين لمرشدها، ويتذللون لنصرالله حزبها في لبنان لتعزيز مكانتهم، وعند أول مفرق خلافي مع حركة الجهاد يفتحون نيرانهم اتهاما وتهديدا..وأخر طبعاتهم كانت ضد مقابلة النخالة لأنه نطق حقا وطنيا…اختلفوا مع الناس بس تعلموا “الوطنية” قبلها!
تنويه خاص: شكلها الفصائل الفلسطينية قررت نقل اللقاءات من “القاهرة” الى مدينة جديدة في بلاد المحروسة من باب التشاؤم والتفائل…قالك يمكن “العلمين” تفك نحس فشلهم..مع أن الفشل فيهم ومش في مكان اجتماعهم..الصراحة انتم النحس..!